أين العمار يا شيخ .. رحلة الصوفية بين سيف الإقصاء وغواية الاحتواء..أكمل صفوت
من حكايات التراث التى أذكرها، قصة الرجل الذى مر بأحد المتصوفة الزهاد فى الصحراء (يقال أنه إبراهيم بن أدهم، المتوفى ١٦٢ هجرية.) وسأله: أين العمار ياشيخ؟
فقال له الشيخ: اتبعني
وظل الشيخ يسير والرجل يتبعه حتى أتى به إلى المقابر.
فقال له الرجل: أسألك عن العمار، فتأتى بى إلى هنا؟
فقال الشيخ: بل هو العمار، لأن الذين هناك (وأشار بيده إلى أسوار البصرة) يأتون إلى هنا، والذين هنا، لا يذهبون إلى هناك.
توضح المروية ما كان قد وقر فى نفسى ومخيلتي سابقا وهو أن التصوف (متمثلا فى الشيخ الزاهد) -فى أى عصر- هو نقيض المدينة، يحيا على اطرافها، غير مندمج فيها، لايدين بقيمها ولا يدخلها إلا زائرا. أما “المدينة” فهى فى هذه المروية -كما كانت فى مخيلتى- تبدو سلبية، لامبالية، أو غير مكترثة، هل تعكس تلك المروية كل الحقيقة عن العلاقة بين المدينة والصوفية؟ وكيف اختلف تعامل المدينة مع الصوفية فى عصر ابراهيم بن أحمد مع تعامل المدينة الحديثة معها؟ هذا ما سيحاول المقال أن يلقى عليه بعض الضوء.
بقلم/أكمل صفوت
طبيب استشاري علاج الأورام بمستشفى جامعة ارهوس بالدنمارك ومن المهتمين بالفكر الديني والإسلام السياسي وهموم المصريين في المهجر.

أطروحتى فى البحث هى أن “المدينة” لم تكن أبدًا لامبالية أو غير مكترثة بالصوفية وذلك لأن المدينة كانت دائما مركز السلطة السياسية والمؤسسات أو الرموز الدينية التقليدية، وكليهما كانا دائما على وعى ودراية بالتوتر والتناقض بين قيمهما وبين الأفكار الصوفية، وقد كان سلاحهما لحل هذا الصراع قديما هو الإقصاء (سواء كان ذلك إقصاء معنويا بالإدانة أو ماديًا بالنفى أو حتى القتل).
أما فى عصرنا الحديث، فقد اكتسبت المدينة بعدا آخر وعنصرا جديدا فى تكوينها ألا وهو “السوق الرأسمالى” بكل تجلياته وبأذرعه الممتدة إلى داخل السياسى والدينى على السواء. الخلاف بين قيم ومفاهيم السوق والمفاهيم الصوفية ليس بأقل حدة من الخلاف مع البعدين السابقين (السياسة والدين التقليدى) إلا أن دخول السوق فى حلبة الصراع قد أحدث تغيرًا نوعيًا فى الأدوات المستخدمة فيه بحيث حل الاحتواء والتسليع محل الإقصاء والنفى.
سأحاول ضرب الأمثلة على هذه الأفكار وأختم مقالى بتساؤل عما يشكله هذا التحول فى أدوات الصراع من تحديات للصوفية وافكارها ووجودها.
خلاف الصوفية مع السياسى والدينى
التصوف رحلة روحية شخصية فردانية هدفها هو الإتصال ومنتهاها هو الإتحاد بالله/المقدس/الآخر الكبير دون وساطة بشر. رغم فردانية التجربة إلا أن محدداتها لا يمكن فصلها عن الإطار الثقافى لزمان المتصوف ومكانه الجغرافى. رحلة المتصوف المفارقة للتقليدى وضعته دائما فى مواجهة المؤسسات الدينية لعصره والتى إعتبرت رحلته الروحية ووسائله فى الوصول إلى أهدافه، محاولة للتمرد على سطوة التدين التقليدى، أو الهرب من سلطة المؤسسة الدينية أو التحلل من الشعائر أو إنكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة.
كذلك فإن بعض المفاهيم الصوفية وممارساتها قد وضعتها فى مواجهة مع السلطة السياسية. ففكرة إمكانية التواصل بين البشرى والإلهي عن طريق إلتماس “العلم” واكتسابه، تعطى كرامة وقدسية ووضعا مركزيا للبشرى وتعلى من شأنه بشكل يضع حدودا لسلطة وسلطان الحاكم على أقدار المحكومين واجسادهم. وليس بغريب على الصوفى الذى رأى أن بإمكانه مخالفة أو التحرر من توجيهات السلطة الدينية وقواعدها أن ينحو نفس المنحى نحو قوانين المدينة وأعرافها المستقرة وهو مانجده متجسدا على سبيل المثال، فى الموالد الصوفية حيث يتم دائما خلق مساحة جديدة غير تلك التى تحكمها وتسيطر عليها الدولة، مساحة تتراجع فيها سلطة الدولة لحساب سيطرة “العامة” فى لحظة مؤقتة من الحكم الذاتى، تتماس وتتلاقى فيها المحددات لما هو الفضاء العام وماهو الفضاء الخاص، ويعاد فيها تشكيل الممارسات المسموحة والمقبولة لكل فضاء ولو إلى حين.
ولايمكن لأى سلطة سياسية مهيمنة الا أن تشعر بالتوتر من تلك المساحات وأن تراقبها وتحاول تحجيمها أو فرض سيطرتها عليها.
الإقصاء كسلاح لحل التناقض
لا أظن أننا يمكننا أن نعتبر الصوفية حركة مقاومة سياسية أو دينية أو أن نتصور أنها يمكن أن تهدد استقرار السلطة السياسية أو سطوة المؤسسات الدينية. فرغم وجود بعض التجمعات والحركات الصوفية إلا أن الصوفية كانت ولا تزال مشغولة بالخلاص الفردى. ودائما ما كان بعدها الروحى يدفعها للتعالى عن الواقع لا محاولة تغييره. إلا أن ذلك لم يمنع المدينة من أن تمارس ضغوطا لتحجيم الصوفية من خلال مؤسساتها الدينية والسياسية. دور المؤسسة الدينية كان بأطياف الإدانة الفكرية من الإستنكار حتى التكفير، فى حين اضطلعت المؤسسة السياسية بالإقصاء الفعلى والذى اختلفت حدته بإختلاف الظرف السياسى والتاريخى.
وسنجد هنا أن لكثير من أئمة التدين التقليدى مثل ابن تيمية (728 هـ) وتلميذه ابن القيم الجوزية (751هـ) مواقف تتراوح بين الإحتفاء ببعض صور التصوف “المعتدل” والهجوم الشديد على بعضها الآخر.
ففى كتابه المسمى “الصوفية والفقراء” دافع ابن تيمية عن قسم كبير من المتصوفة، فقال: “إن طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة… والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب…”.
غير أن ابن تيمية من الناحية العملية، لم يكتف بتوجيه النقد”المتوازن” للتصوف فحسب، بل إنه مارس هذا النقد بشكل عملي، عندما دخل في العديد من المناظرات مع أشهر الجماعات الصوفية في عصره كالرفاعية وأتباع بن عربى. وفى كتابه “مجموع الفتاوى” سُئل عما ورد في كتاب “فصوص الحكم” لمحيي الدين بن عربي(638هـ) من أفكار تميل للقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، فقال بإنه “كفر باطنا وظاهرا” وهاجم مؤلف الكتاب، وغيره من الصوفية الذين انتهجوا ذات النهج، كابن الفارض (632 هـ)، وابن سبعين (669 هـ)، وصدر الدين القونوي (672 هـ)، فقال: “فأقوال هؤلاء ونحوها: باطنها أعظم كفرًا وإلحادًا من ظاهرها فإنه قد يظن أن ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين أهل التحقيق والتوحيد وأما باطنها فإنه أعظم كفرًا وكذبًا وجهلًا من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام”.
الاتهام بالكفر ليس بالأمر الهين لما قد يستتبعه من إهدار للدم وإزهاق للروح.
وهو ما دعا الغزالى -وهو من هو- إلى التعبير عن أفكاره الصوفية بإسلوب حذر نرى فيه الحرص البالغ على التأكيد على الاعتدال والوقوف فى منتصف الطريق بين الأقطاب الفكرية المختلفة وذلك عن طريق تأكيد على الكثير من “الضوابط” التى قد ترضى السلطة السياسية كما ترضى السلطة الدينية. كقوله فى العلم والمعرفة، أنه يمكن إدراك الله والعلم به دون النظر فى الكون والموجودات. نافيا بذلك أى دور فعال أو إيجابى للإنسان وإصراره على التأكيد على فكرة النبوة ومقامها وكذلك إصراره على إستخدام تعبير الفناء فى الله نافيا ليس فقط الحلول او الامتزاج أو التخلل بل مجرد إمكانية الوجود البشرى المستقل فى حال القرب مع الإلهى.
ولا يمكننا أن نلوم على الغزالى هذا الموقف إذ أن التاريخ يذكر لنا قائمة طويلة بأسماء الأشخاص الذين يُفترض أنهم أُعدموا بسبب آرائهم وممارساتهم الصوفية ومنهم على سبيل المثال: الحسين بن منصور الحلاج وذلك في عام 922، وعين القضاة الهمداني في عام 1131، وشهاب الدين السهروردي في عام 1191، والشيخ العثمانى بدر الدين في عام 1420، وسرمد كاشاني (فى الهند) في عام 1661. بل حتى فى عصرنا الحديث يمكننا ببحث بسيط على الإنترنت أن نجد حالات لإعدام صوفيين بسبب افكارهم الدينية حتى عام ٢٠١٨. غير أن هذا أصبح يتم لا على يد السلطات السياسية للدول الحديثة بل على يد الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام.

المدينة الحديثة ودخول السوق
ببعدها عن المفاهيم السائدة للدين والسلوكيات الإستهلاكية للمجتمعات الرأسمالية الحديثة يمكن اعتبار الصوفية فى المدينة الحديثة توجه فكرى راديكالى معارض للتدين التقليدى وآليات السوق. غير أنه فى المقابل فالتصوف “منتج” إنسانى يمكن تحويله لسلعة تباع وتشترى طبقا لاحتياجات العرض والطلب. ويبدو أن المدينة “الحديثة” -فى عصرنا الحاضر رأت فى هؤلاء الزهاد على أطرافها ما يمكن تسليعه، والإستفاده منه واحتوائه والتربح منه فى سوقها الكبير. وأنها قد بدأت بالفعل فى سعيها نحو ذلك. ونستطيع أن نرصد لتسليع التصوف عدة أشكال منها مثلا:
– التسليع السياحى: ومن أمثلته تنظيم رحلات للأضرحة والأماكن الصوفية للزيارة والمشاهدة من بعيد. وقد نجد وسط هذه الأنشطة أمثلة فجة تكتفى فقط بإستخدام كلمة صوفية دون أى محتوى يقترب ولو قليلا من أى ممارسات أو أماكن صوفية.
– التسليع الثقافى: ومن أمثلته بيع الكتب والأشعار، واللوحات الفنية وصور لبعض الرموز أو المقولات الصوفية.
هذا النوع من “الاحتواء” يبدو مشكلا لما ينطوى عليه من علامات “القبول” و”الإحتفاء”. غير أن المتأمل لآليات التسليع سيكتشف زيف القبول وسطحية الإحتفاء.
ففى حالة التسليع السياحى يغيب عن تلك الرحلات البعد الروحى و الجهد الفردى. وبغياب رحلة الإستكشاف الفردية يغيب المعنى. الممارسات الصوفية لا يمكن معاينتها أو فهمها من بعيد ولا يمكن تقديمها جاهزة كالوجبات السريعة.
وفى حالة التسليع الثقافى يتم إخضاع الأشياء والمعانى والمفاهيم التى يتم إستخدامها لآليات التسليع مثل التسطيح والتنميط والإختزال والمزج بين متباينات فى سلعة واحدة معزولة عن سياقها.
التصوف فى جوهره حركة نحو التحرر، فى حين يسعى تسليع التصوف إلى استلاب التحرر لإخضاعه لآليات السوق. تسليع التصوف إذا ، عكس التحرر، وهو توجه لم ينبع من داخل الصوفية كحركة وفكر وإنما من داخل المدينة الحديثة والفكر الرأسمالى و يهدف بالأساس إلى تراكم ارباح مادية لكيانات كبيرة وشركات متعددة الجنسيات ليس لها علاقة بالحركات الصوفية أوالفكر الصوفى.
هل كانت الصوفية ضحية دائما
يروى لنا ابن حجر العسقلاني (852 هـ) في كتابه “الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة”.
قصة المخاصمة التي وقعت بين ابن تيمية والشيخ الصوفي نصر المنبجي، الذي كان من أتباع ابن عربي، فقال:
“وَكَانَ من أعظم القائمين عَلَيْهِ الشَّيْخ نصر المنبجي لِأَنَّهُ كَانَ بلغ ابْن تَيْمِية أَنه يتعصب لِابْنِ الْعَرَبِيّ فَكتب إِلَيْهِ كتابا يعاتبه على ذَلِك فَمَا أعجبه لكَونه بَالغ فِي الْحَط على ابْن الْعَرَبِيّ وتكفيره فَصَارَ هُوَ يحط على ابْن تَيْمِية ويغري بِهِ بيبرس الجاشنكير وَكَانَ بيبرس يفرط فِي محبَّة نصر ويعظمه…”.
هذا الخلاف تسبب في سجن ابن تيمية في القاهرة لفترة، قبل أن يتم نفيه إلى الإسكندرية. فى هذة القصة الشيخ الصوفى لم يكن الضحية بل كان الجانى، الذى استغل قربه من السلطة السياسية لإقصاء مخالفيه.
وليس موقف الشيخ المنبجى بإستثناء فى التاريخ، فبالرغم من أن التصوف فى جوهره، حالة تمرد فرد للتحرر من قهر سلطة المؤسسة الدينية، فإنه قد يتحول الى سلاح قمعى فى يد السلطة السياسية إن دخلت فى صراع مع المؤسسة الدينية لعصرها. بمعنى آخر، فإن كانت السلطة السياسية للمدينة الحديثة قد فقدت قدرتها على إقصاء الصوفية بنفى رموزها أو قتلهم كما كانت تفعل فى الماضى فإنها مازالت قادرة على “احتوائها” كما يفعل السوق وإستخدامهم فى لعبة السياسة، وهو ما قد نجد أصداء له فى عصرنا الحالى فى مصر مثلا، فنجد احتفاء من السلطة السياسية بنموذج الشيخ على جمعة، حين تتوتر علاقتها بمشيخة الأزهر.
وإذا نظرنا إلى زاوية “التسليع” التى انتقدناها سابقا فإنه من المستحيل نظريا أن نجزم إن كان الرواج الملحوظ الحالى للأفكار الصوفية و إزدياد الإهتمام بها هو السبب الذى أسال لعاب السوق وجعله يلهث وراء تسليع التصوف أم أن هذا الرواج للتصوف هو نتيجة لذلك التسليع. إذ أنه لو كان الأمر كذلك فلن تكون الصوفية وأفكارها ضحية التسليع بل أول المستفيدين من نتائجه أو من الدعاية المصاحبة له.
خلاصة القول إذا هو أنه رغم تواتر محاولات “المدينة” بسوقها وبسلطاتها السياسية والدينية أن تحل تناقضها مع التصوف تارة بالإقصاء وتارة بالاحتواء، فإن العلاقة بين المدينة والصوفية أعقد من أن يتم اختزالها فى دورى “الظالم” و”الضحية” خاصة فى عصرنا الحديث.
أما بعد
كان الصوفيون ومازالوا أقلية، لكنهم حافظوا على موقع متميز فى التراث الإنسانى عموما والإسلامى خصوصا، بأفكارهم الفلسفية وممارساتهم الروحية وإسهاماتهم الفنية. ويقينى الشخصى أنه ما كان لهذه الأفكار أن تستمر فى ظل محاولات الإقصاء والتهميش المستمرة مالم تكن تملأ فى النفس الإنسانية فراغا أصيلا وتلبى إحتياجا أساسيا. وقناعتى الشخصية كذلك إننا الآن فى عصرنا الحديث أحوج مانكون لهذه الأفكار وتلك الممارسات، وأن هذا الإحتياج هو السبب وراء الإهتمام الواسع الحالى بالصوفية ورموزها وأفكارها.
يتحدث الصوفيون كثيرا عن مفهوم “الرحلة”. ورحلة الصوفية شاقة لأنها مفارقة للتقليدى ولكون الصوفى يخوضها وحيدا ولإنها تحتاج لدأب وإصرار وإخلاص ووعى دائم بأنه سيقوم خلالها بالعديد من الاختيارات ويمر بكثير من الإختبارات. وأنا أرى أن أعظم إختبارات الصوفية التاريخية هى غواية “الاحتواء” الحالية. فهى غواية مغلفة بمظاهر القبول والإحتفاء سواء من قبل السلطة السياسية أو السوق. وهى غواية تعد الصوفى بإمكانيات أكبر للتأثير والانتشار.
المدينة الحديثة تعد الصوفى بمكان متميز وسط سوقها المزدحم. ستمهد له الطريق وتقوم برص بضاعته على الأرفف. إن دخل الصوفى من الأسوار، سيجد الكثير من الزبائن الراغبين المتلهفين، لكنه لن يجد من بينهم من يسأله:
أين العمار ياشيخ؟
التصوف والمسرح ..بهاء الريدي
المنهج الصوفي في المجاز والتأويل علي غرس الله
التصوف في المدينة الحديثة خمسة مداخل بقلم وليد الخشاب
صورة جلال الدين الرومي في الوسائط البصرية عبر العصور بقلم نهى حنفي
لمراسلة المجلة بمواد للنشر في صورة ملف word عبر هذا الايميل:
salontafker@gmail.com
اشترك في صفحة تفكير الثقافية لتصلك مقالات تفكير اضغط هنا
تابعنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
تابع قناة جمال عمر علي يوتيوب شاهد قناة تفكير علي يوتيوب تابع تسجيلات تفكير الصوتية علي تليجرام انضم لصالون تفكير علي فيسبوك
شارك المحتوى
اكتشاف المزيد من تفكير
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




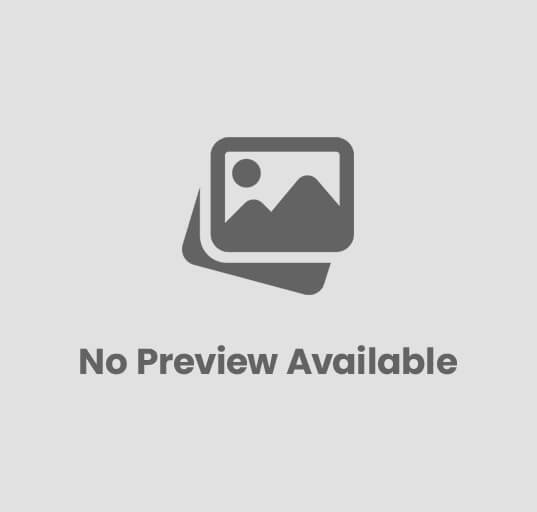







0 comments