الأطلال وعلاقتها القديمة بالشعر الحديث .. بقلم: محمد عرش العظيم
بقلم: محمد عرش العظيم الاندونيسي

إذا تتبعنا المعاني المندرجة تحت شعر الوقوف على الأطلال في العصر الجاهلي سنجدها دائمًا مرتبطة بالمواصفات الديارية التي تبدو من خلال الشعر العميق للذكريات الماضية مع من نزل فيها. فهي مسكنهم ومحفظهم التي تظهر كل الآثار من تعاطيه بأهله أو حبيبته. وقد أودت تلك الديار وذهبت، وما لها من ذهابها للساكن سوى البقايا من الرسوم والأطلال التي أثرت في نفسه، فجعل ذهابها أن ينشد أبياتًا من الشعر محاولًا ذكر سابقاته، وتسمى بالأبيات الطللية.
وقد حاز كلام الشعراء قديمًا على معنى الأطلال بجملة عديدة على مر العصور الأدبية، غير أن ما تعد أساسية فيها، واعتنى بها الشعراء في شعرهم اعتناء كثيرًا، يغني عن غيرها، ويكررونها وافرًا، هي سؤال الديار وتكليمها واستعجامها عن الجواب، ووصف الديار ووصف بقاياها، وتخريب الديار، وبيان الحيوان الذي يألف الديار بعد خلائها، وحالة الشاعر النفسية حين الوقوف على الديار.
وأقتصر في هذا البحث صرحَ الأول؛ لأن فيها ما يشعر بتعمق شعر الشاعر، وسحيق الاتصال القلبي بالمكان الذي باتت لياليه فيه، حتى صار كأنه يكلم الأحياء ويسمعون نداءه ويجيبون دعوته.
فمن دأب شعراء العرب في شعر الوقوف على الأطلال أنهم ينادون الديار بعد أن وقفوا عليها، ويسألون عن ساكنيها الذين حلوا محلها في الزمن الماضي. ويعتادون أن يطلبوا إليها تكليمهم وتحديثهم عن أخبارهم. وقد استطاعوا أن يجعلوا لهذه الديار أشخاصًا تسمع لهم ما يقولون، ولكنهم لم يصلوا إلى أن يجعلوها تجيبهم، وتحدثهم حديث الأيام الماضية، والذكريات الخالية. وإن إجابتها على أسئلتهم ودعواتهم أن تصمت لأنها خلت من الناس واستحالت على الكلام. نأخذ مثلًا من قول امرئ القيس:
يـا دارَ مـاوِيَّةَ بِالـحائِـلِ ۞ فَالـسُهبِ فَالخَبـتَينِ مِن عاقِلِ صُمَّ صَداها وَعَفا رَسمُها ۞ وَاِستَعجَمَت عَن مَنطِقِ السائِلِ |
ففي هذا البيت أبان امرؤ القيس؛ أن الدار قد هلكت وضاعت حتى لا تقبل أي صوت، واستعجمت فلا تجيب على منطق السائل الواقف عليها.
والنظام الغالب في شعر الوقوف على الأطلال هو سؤال الديار عمن سكنوا فيها من جانب الشاعر، ثم محاولة الكلام معها والحكاية إليها، هذا من ناحية. والاستعجام عن الجواب من جانب الديار في جميع الأحوال من ناحية أخرى. وأغلب الهيئة التي التصقت الديار بها في معرض سؤالها والكلام معها واستعجامها عن الجواب هي الخرس والصم والعجمة. قلت:
ولم تبد صوتًا إن سألت مدارس ۞ فهل خـربها حام وهل هي أخرس؟ |
نعم، فالمدارس خرساء، لا تكلم الواقف عليها، وليست الخرب هي التي تجعلها مستعجمة لا تلقي إلى الواقف عليها جوابًا. وكان بعض الشعراء أمكنوا الوصول إلى درجة نفح الديار الروح، والقدرة على الكلام، ولكنها تضعف، وتخفي، ولا تكاد تبين شيئًا. مثل ما قاله عوف ابن عطية:
وَقَـفْـتُ بـهـا أُصُــلاً مـــا تُـبِـيـنُ ۞ لسـائـلِـهـا الــقــولَ إِلاَّ سِــــرارَا |
فقد نسي الشاعر عن نفسه، وتجاوز في الذكريات، حتى تصور في خياله أن الديار أبانت إليه القول خافتًا رقيقًا، كأنها تحكي إليه أحزانًا أصيبت لها، وتهمس في أذنيه ما خلت لها الأيام من ذكريات وأحداث.
الأطلال في الشعر المعاصر
أود في بيان هذه القضية أن أضع ضابطًا حاويًا على ما تأسس به الشعر حتى يمكن أن يصل إلى الآخرين، وهو أن للشاعر في شعره أن يستعمل الصور التي تهذب طريقه لإيصال المعاني التي عبرت عما في نفسه إلى الآخرين، بغض النظر من كونها واقعية أم لا، أو كونها تاريخية أم معاصرة، وذالك لا مجال لإثباته؛ لأنه أمر ليس في حيز منه.
والأطلال في نفسها دلت على البقايا من خرب الديار التي تبقى آثارها في الأرض -كما مر- وهي صورة قديمة وقعت في العصر الجاهلي وما بعده، ولكنها ليست مجرد صورة بيئية أحاطت بحياة الشاعر، وإنما هي جزء أدبي شعري في نفس كل شاعر.
فالأطلال بقيت على صورتها أيا كان الشاعر والعصر، وليس هناك سبب أبطل استعمالها في العصر الحديث أو في الشاعر العجم. والسبب في تتابعها خلال العصور، وانبساطها إلى العصور الحاضرة البعيدة عن البادية وصورها وأطلالها هو أنه راجع إلى السر نفسه الذي من أجله اتخذ هذا الشعر شبه قاعدة فنية لافتتاح القصائد، وهو جمال هذا الشعر، وحسن موقعه في القلب، وإثارته في النفس الإنسانية شعورا فنيا خاصا وإن اختلفت العصور وتغيرت البيئات. وأما كون الشعراء الأعاجم الذين كتبوا الشعر وذكروا الديار والصحراء فيه مع أنهم لا يحفلون بماضي العرب، ولا يعطفون إلى صحرائهم، فكيف يكتبون عن الديار وصور الصحراء القديمة في شعرهم؟ فالجواب: أنهم في الحقيقة قد اهتموا بصور الصحراء ومنها أطلال الديار ورسومها في شعرهم، والعلة في ذالك انسياق هؤلاء الشعراء مع الشعور العام وخضوعهم لهذا الضغط المعنوي الشديد الذي كانت توقعه اللغة العربية، والأدب العربي، والذوق العربي.
فالقضية المتأثرة بالأطلال في الزمان المعاصر هي أنها تعبير قلبي عن غياب الأشياء المعشوقة وذهابها عن نفس الشاعر، وأراد الشاعر أن يعبر عما تكونت في نفسه من تلك الشعور بما يلائم حال العرب عند أن صدفوا غياب الأهل والمحبوب عن الديار؛ لأنهم لما ارتحلوا عنها لا تصلح لأن تسكن فخربت، ولا تبقى إلا رسومها وأطلالها، فهذه الصورة هي التي جعلها الشاعر المعاصر صورة بيانية لما في نفسه.
مثلا إن قلنا: كتبنا الكتب بالريشة، فهل هناك عائق لفهمنا أن كتبنا الكتب بأيدينا؟، طبعا، لا. وإنما هي صورة بيانية لحالنا المماثل لحال الكتاب الذين كتبوا بالريشة، مع أنا كتبنا مثلًا بالقلم أو عبر كمبيوتر. و خذ مثالًا آخر من قولي:
وغى الحرب يأتيها بدرع مصقل ۞ أما ذو الفقار يبتغي كل سائل |
هل حُجِزتَ من فهم أنه اشترك في الحرب؟ طبعا، لا، ولكنني إنما صورت ما كان من حاله عند وقوع الحرب بما وقع في العصور القديمة مثل الحروب التي غزاها سيدنا علي -رضي الله عنه- حاملا ورافعا سيفه ذا الفقار التي تفتقر كل دم سائل.
فالحاصل: ما دام صفى سبيل الفهم للمعنى المراد من أسلوب طللي –كما مثلت– فهو صحيح ولا مانع له. ومن منعه على قول “لزوم التعبير بالعصر الحال” فهو أقر بما لا يقبله العقل، وذالك إلزام ما لا يلزم. وعلى هذا فالأطلال ليست هي إلا مجرد تعبير شعوري فني في قضية الشعر والشاعر المعاصرتين، وهي تتناسب دائما بالصورة القديمة في كونها معبرة عن السحيق الاتصالي بالديار التي باتت ليالي ساكنيها فيها.
لمراسلة المجلة بمواد للنشر في صورة ملف word عبر هذا الايميل:
salontafker@gmail.com
اشترك في صفحة تفكير الثقافية لتصلك مقالات تفكير اضغط هنا
تابعنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
تابع قناة جمال عمر علي يوتيوب شاهد قناة تفكير علي يوتيوب تابع تسجيلات تفكير الصوتية علي تليجرام انضم لصالون تفكير علي فيسبوك
شارك المحتوى
اكتشاف المزيد من تفكير
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




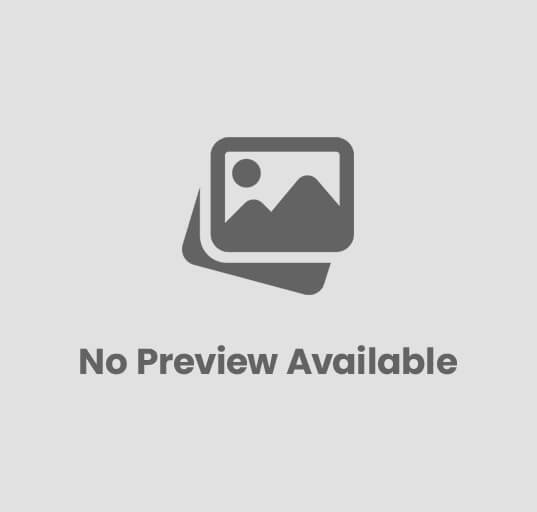







اترك رد