البحث عن الحكمة .. بقلم: أحمد يوسف
بقلم: أحمد يوسف (رحمه الله)
ما الحكمة؟
هل هي تلك الملكة المتوجة على قمة هرم المعرفة الإنسانية؟ حيث تأتي البيانات عند قاعدة الهرم، يليها المعلومات، التي بتجميعها نحصل على المعرفة، وبالتعمق فيها وتأملها، نجني الثمرة والفائدة والمعنى أقصد الحكمة.
أم هي نوع خاص من المعرفة مبثوث في بعض الأسفار؟ كأمثال سليمان وسفر أيوب ومزامير داوود والسفر اليوناني المسمى باسم الحكمة، ويتكون من تسعة عشر فصلا، والمنسوب لسليمان.
وفيه يتغزل سليمان في الحكمة كما يتغزل محب فى معشوقته، وفيه: “ولذلك صليت من أجل الفهم فنلته”. ويتفق محتوى كتاب الحكمة مع قول ابن عاشور أن الحكمة كانت تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصاية بالخير وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة وكليات جامعة لجماع الآداب.
أم هي الفلسفة؟ كما اعتبرها العديد من المفكرين كابن رشد في فصل المقال. وهي تلتقي مع الفلسفة فى التساؤل واستخدام المعارف والوسائل المتاحة للوصول إلى إجابات، وأهم وسيلة العقل.
وفي رحلة البحث عن الحكمة نبحث عنها في آخر كتاب للوحي الإلهي. ففي القرآن الكريم الحكمة مؤتاة للأنبياء ضميمة للكتاب
وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ [آل عمران: 81]
فهل بذلك يمكن اعتبارها وصفا للكتاب؛ حيث يتعامل المؤمنون مع الكتاب أنه منزل من عند الله ويتعامل غير المؤمنين معه على أنه كتاب حكمة؟ أم أنها وصف للكتاب حيث أن الحكمة مبثوثة في آياته؟ “ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِۗ” [الإسراء: 39]، أم أن وحي الله نوعان: الكتاب ويختص بالعقائد والتشريع، والحكمة تختص بالموعظة والعبرة “حِكۡمَةُۢ بَٰلِغَةٞۖ فَمَا تُغۡنِ ٱلنُّذُرُ” [القمر: 5] وخص بالذكر في إيتائها آل إبراهيم وداوود وآتاها لقمان
وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا لُقۡمَٰنَ ٱلۡحِكۡمَةَ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِلَّهِۚ [لقمان: 12]
بل هي رزق يؤتيه الله من يشاء من عباده
يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ [البقرة: 269]
والله عز وجل يعلمها عيسى
وَيُعَلِّمُهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ [آل عمران: 48]
كما يستخدم القرآن لفظ التنزيل
وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ [النساء: 113]
والحكمة مطلوب تذكرها عند مواجهة أعتى المشكلات الخاصة مثل مشكلة الطلاق
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ [البقرة: 231]
كما أن أزواج النبي مطالبات بتذكرها
وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ [الأحزاب: 34]
كما أن عيسى استخدمها في بيان بعض ما يختلفون فيه
وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدۡ جِئۡتُكُم بِٱلۡحِكۡمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي تَخۡتَلِفُونَ فِيهِۖ [الزخرف: 63]
والنبي مأمور ببتعليمها مع الكتاب أي أنها قابلة للتعلم
لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ [آل عمران: 164].
وباستقراء بعض آراء المفسرين قد نصل إلى بغيتنا ففي معجم ألفاظ القرآن الكريم الصادر عن مجمع اللغة العربية عام 1988 يذكر للحكمة معنيان الأول: صواب من قول وعمل، وعلم نافع. والمعنى الآخر: عظة وعبرة ويوجد فى حكمة بالغة.
وذكر ابن جزى فى تفسير يؤتى الحكمة: قيل المعرفة بالقرآن وقيل النبوة وقيل الإصابة فى القول والعمل. وبين الشوكاني أن الحكمة هى العلم، وقيل الفهم، وقيل الإصابة فى القول، وقيل النبوة، وقيل العقل، وقيل الخشية، وقيل الورع، وأصل الحكمة ما يمنع من السفه، وهو كل قبيح.
وقد قصرها الشافعى على السنة. وقد أوضح ابن عاشور أن من فسر الحكمة بالسنة فقد فسرها ببعض دلائلها. ونقل القرطبي عن ابن زيد أن الحكمة العقل فى الدين. وبين مقاتل بن سليمان أشهر مفسري التابعين أن تفسير الحكمة في القرآن الكريم على أربعة وجوه:
أحدها مواعظ القرآن الكريم وثانيها الحكمة بمعنى الفهم والعلم وثالثها الحكمة بمعنى النبوة ورابعها القرآن الكريم بما فيه من العجائب والأسرار. وأما الرازى فقد ذكر أن الحكمة لا يمكن خروجها عن معنيين هما العلم وفعل الصواب. ويمكن استشراف الآية الكريمة والتى تصف حكمة سليمان فى سورة الأنبياء
فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ [الأنبياء: 79] فحكمة سليمان لها علاقة بالفهم والعلم.
ويضع ماجد الكيلاني تعريفا حداثيا للحكمة بأنها القدرة على اكتشاف السنن والقوانين التى تنظم ظواهر الكون والحياة ثم تحويل هذه السنن والقوانين إلى تطبيقات عملية فى مختلف ميادين الحياة.
فالحكمة تعمل على إشاعة التفكير السنني القانونى بدلا من الحمية والظن والهوى التى ميزت التفكير الجاهلي، وإشاعة العمل المحكم القائم على الإعداد والتخطيط بدل الارتجال.
وبالنظر إلى قول ابن زيد أنها العقل فى الدين. ولماذا العقل فى الدين فقط؟ لماذا لا يكون العقل فى كل شئون الحياة؟ وبذلك يكون تعليم الكتاب هو الوحى الإلهى، وتكون الحكمة استخدام العقل. تلك النفحة الإلهية للإنسان والنعمة الكبرى. ولعل من المناسب استدعاء قول المعري
كل عقل نبى.
وتقتضي الحكمة الانفتاح على ما عند المجتمعات الأخرى من علوم ونظم ووسائل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:
الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق الناس بها
ومن الأمثلة على استخدام التفسير السننى فى تفسير الآية الكريمة
مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَثَلِ رِيحٖ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتۡ حَرۡثَ قَوۡمٖ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَأَهۡلَكَتۡهُۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنۡ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ [آل عمران: 117]
جاء في تفسير الآية في القرطبي قال: أي أنهم ظلموا أنفسهم إذ زرعوا في غير وقت الزرع. وفي الآية
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٱللَّهَۖ [البقرة: 282]
جاء فى تفسير الطبرى قال كعب: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد، فلما حل ماله جحده صاحبه، فدعا ربه فلم يستجب له؛ لأنه عصى ربه.
وبالحكمة يمكن حل معضلة توتر القرآن التي أثارها جمال عمر فى كتابه المعنون بهذا الإسم فالحكمة العلم، والحكمة الفهم، والحكمة العقل. فنحن نرجح بالحكمة تنزيه الله وتقديسه فى مجمل القرآن الكريم وله الصفات العلا سبحانه وليس كمثله شيء. وفي الأحكام الفقهية العقل والفهم، أي الحكمة، ترجح التعامل مع مقاصد الشريعة والحكمة تقتضي التركيز على اللباب، وعدم الاقتصار على القشور.
ولنأخذ على ذلك مثلا في التعامل مع القرآن الكريم حيث يركز أغلب المسلمين على تعلم أحكام التجويد، وفي رمضان يركزون على عدد مرات ختمه؛ في حين أن الأساس هو فهم معانيه وتبني قيمه في الحياة.
فلقد فهم بعض المسلمين أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان فإذا بهم يشغلون كاسيت يردد ويكرر السورة بالبيت؛ في حين أن سورة البقرة التي في أولها وصف للقرآن أنه هدى للمتقين، وفيها أحكام العبادات كالصيام والإنفاق، وفيها أحكام الأسرة، وفيها بيان للإيمان وابتهال المؤمنين، فهل يقرب الشيطان أحدا يعقل سورة البقرة ويعمل بها في حياته؟
هناك قول للإمام الشافعي عن سورة العصر أنه لو لم تنزل إلا هي لكفتهم. وهذا فهم عظيم، فهي تشيد بقيمة الإيمان، وقيمة العمل الصالح، وقيمة التواصي بالحق، وقيمة التواصي بالصبر، يضمن تطبيق هذه القيم مجتمعا قويا سديدا.
ولو طبقت هذه المعايير على داعش وهي معايير قرآنية لاتضحت منزلتهم على سلم درجات الإيمان.
الحكمة أنثى لجمالها ونضارتها ولعطائها اللامحدود ولقدرتها على ولادة معاني متجددة فتية تناسب العصر ولا تتعارض مع العقل والعلم.
والحكمة تكبح جماح العقل المذكر بما له من نزوات فكرية وخيال غير محدود وتجارب جبارة فتأتي الحكمة وتزرع على أرض الواقع شجرة باسقة يستظل بها الإنسان في مسيرته المعرفية الحثيثة تحت شمس الفكر.
الكتب نصوص، والنصوص أجسام، والحكمة روحها، وهناك من يكتفى بحفظ النصوص، كما أن هناك من يأنس بالأرواح، ويسعى لاستكناه سرها.
لمراسلة المجلة بمواد للنشر في صورة ملف word عبر هذا الايميل:
salontafker@gmail.com
اشترك في صفحة تفكير الثقافية لتصلك مقالات تفكير اضغط هنا
تابعنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
تابع قناة جمال عمر علي يوتيوب شاهد قناة تفكير علي يوتيوب تابع تسجيلات تفكير الصوتية علي تليجرام انضم لصالون تفكير علي فيسبوك
شارك المحتوى
اكتشاف المزيد من تفكير
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




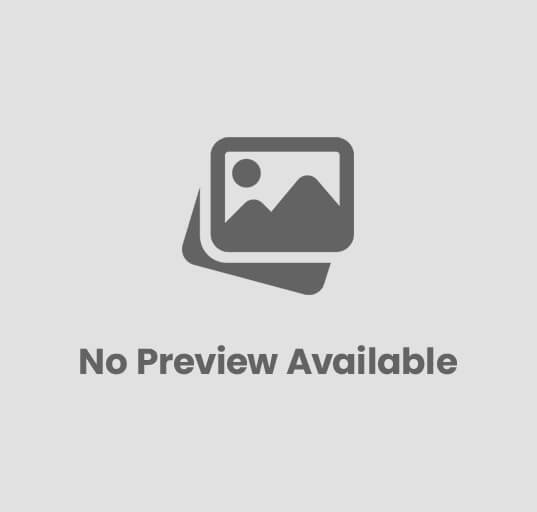







اترك رد