النسخ بين القرآن الكريم وآراء المفسرين .. بقلم: عصام الشريف
بقلم: عصام الشريف

برزت في الباب الثالث من كتاب مقدمة عن توتر القرآن للكاتب جمال عمر فكرة الناسخ والمنسوخ، كأحد الحلول التي طرحها المفسرون لرفع التوتر عن القرآن. فهل أفلحت هذه الفكرة واستطاعت أن تزيل الالتباس عن فهم كثير من الآيات التي يبدو التوتر من معناها؟ أم أنها لم تكن حلًا ناجعًا؟

في هذا البحث سنحاول الإجابة عن هذا السؤال.
النسخ ” لغويا”
يُعرِّف ابن منظور1 في “لسان العرب” النسخ بأنه اكتتاب عن معارضة؛ أو أنه اكتتابك كتابًا عن كتاب. حرف بحرف والاستنساخ هو كتب كتابًا عن كتاب. ثم ينتقل لتعريف آخر ويقول :النسخ إبطال شيء وإقامة شئ مكانه؛ ثم يستشهد بالٱية: “ما ننسخ من ٱية” ويقول: تقول العرب نسخت الشمس الظل يعني إزالته.
من تعريفات المعجم نجد أن استخدام لفظ النسخ هو بمعنى الإثبات، وحتى قول ابن منظور نسخت الشمس الظل، والمعنى الأقرب هو أن الشمس تثبت الظل وتوجده لا تزيله أو تلغيه؛ وكذا استخدامنا له في لغتنا المتداولة، أن النسخ معناه عمل نسخة طبق الأصل من الشيء وليس إزالته. واستشهاد ابن منظور بآية سورة البقرة هو مصادرة على المطلوب، وتأثر برأي فقهي أو الرأي السائد فقهيًا، وليس بحث في المعنى.
النسخ في القرآن الكريم
وردت كلمة”نسخ” في القرآن الكريم على مستوى الجذر في أربعة مواضع..
﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾2
﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾3
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾4
﴿هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾5
نلاحظ أن المعنى الواضح في سورة الجاثية “إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون” هو أن الإنسان يتناول كتابه، وأن الكتاب كان يتم تسجيله أو يتم عمل نسخة فيه من الأعمال وليس إزالتها. وأن هذه النسخة سنتناولها في حياتنا الأخرى.
وفي سورة الحج، نجد أن نسخ الله لما يُلقى الشيطان ليس إزالته، ولكن إثباته وعمل عدة نُسَخ منه والدليل على ذلك أن الآية تقول “ليجعل ما يُلقي الشيطان فتنة….”. فكيف تكون فتنة وهي غير موجودة؟ ولكن الفهم الأقرب هو أن الله يثبت ما ألقى الشيطان ليكون فتنة للقاسية قلوبهم.
وفي سورة الأعراف، “أخذ الألواح وفي نسختها.. ” فلو كانت نسختها تعنى إزالتها فكيف أخذها رسول الله موسى؟ فالمعنى كذلك هو الإثبات وليس الإزالة.
نأتي للآية في سورة البقرة، وهى التى استند إليها الفقهاء فى أن معنى النسخ هو الإزالة. تتكلم الآية عن الآيات التي أنزلها الله فهل تقصد آيات القرآن أم الآيات التي أُنزلت مع الرسل عامة؟
لنحاول فهم الآية التي قيل إنها تجيز النسخ في سياق آيات سورة البقرة، والآية السابقة لها مباشرة تتحدث عن عدم رغبة أهل الكتاب والمشركين أن ينزل خيرًا على غيرهم من الناس.
﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾6
تأتي الآية في سورة البقرة “ما ننسخ من ٱية.. ” بعد الآية التي توضح أن نزول الآيات لا يمنعه رغبة أحد، وأن استنساخ الآية أي نقل نسخة منها مطابقة لها من كتب أهل الكتاب ممكن. وأن من الممكن أيضًا أن يُنسي الله الناس الآية. وهنا النسيان بمعنى التجاهل. ويظهر من هذا الفهم الاتساق بين مفردات الآية، وأن النسخ بمعنى نقل نسخة مطابقة، وعكس ذلك هو تجاهلها. ولو كان المعنى هو الإزالة لكانت المفردات تؤدي لنفس المعنى. وبالتالي لا يكون هناك حاجة لتكرار المعنى.
والسؤال الآن: لماذا حاول المفسرون والفقهاء إثبات النسخ في القرآن، بل وتمادوا في استخدام مفهوم النسخ ليكون هناك مرويات تنسخ آيات القرآن الكريم؟والسؤال الثاني والأهم هو: هل يمكن فهم الآيات التي قيل بنسخها في إطار متسق مع الآيات الأخرى المزعوم أنها ناسخة؟
السؤال الأول ربما يحتاج بحث مطول دون الدخول في أغراض ونيات الآخرين، ولكن بحث عن نتائج ما آلت إليه هذه الفرضية. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، فأعتقد أن الآيات يجب فهمها في إطار نَسَق لا تعارض فيه، بناءً على آية ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾7 وأن آيات القرآن تُفهم في هذا الإطار دون اللجوء لفكرة الحذف والإلغاء.
———————————————————————
- ابن منظور (630- 711 هـ / 1232- 1311 م) أديب ومؤرِّخ، وعالم عربي في الفقه الإسلامي واللغة العربية. من أشهر مؤلفاته معجم لسان العرب. ↩︎
- [ البقرة: 106] ↩︎
- [ الأعراف: 154] ↩︎
- [ الحج: 52:53] ↩︎
- [ الجاثية: 29] ↩︎
- [ البقرة: 105] ↩︎
- [ النساء: 82] ↩︎
لمراسلة المجلة بمواد للنشر في صورة ملف word عبر هذا الايميل:
salontafker@gmail.com
اشترك في صفحة تفكير الثقافية لتصلك مقالات تفكير اضغط هنا
تابعنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
تابع قناة جمال عمر علي يوتيوب شاهد قناة تفكير علي يوتيوب تابع تسجيلات تفكير الصوتية علي تليجرام انضم لصالون تفكير علي فيسبوك
شارك المحتوى
اكتشاف المزيد من تفكير
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




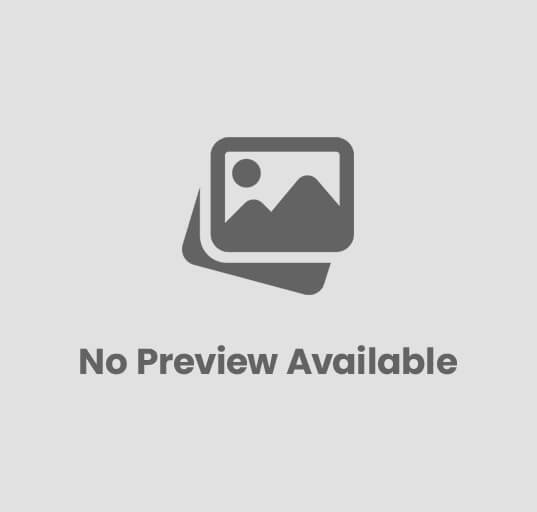







اترك رد