علاقة الأدب والفن بالسياسة في رؤية غالب هالسا … بقلم: شادي عمر الشربيني
بقلم: شادي الشربيني

أكثر من ثلاثة عقود انقضت على رحيل الكاتب والروائي الأردني غالب هلسا الذي ولد ومات في اليوم نفسه (18 ديسمبر – كانون أول 1932، 18 ديسمبر – كانون أول 1989)، وكان غادر بلده عام 1956، ملاحقاً لكونه عضواً في الحزب الشيوعي الأردني، وعاد إليه في كفن بعد وفاته بأزمة قلبية في العاصمة السورية دمشق. وما بين ذلك الخروج وتلك العودة المأساوية تنقَّل غالب بين عواصم عربية عديدة، بين بيروت وبغداد والقاهرة ودمشق، حيث كان على الدوام جزءاً من الحركة الثقافية والجدل المحتدم في حياة كل عاصمة عاش فيها، بغض النظر عن طول الإقامة أو قصرها. لكن إقامته في القاهرة كانت الأطول، والأكثر تأثيراً في تجربته الإبداعية وتكوينه الثقافي، وكذلك في الموضوعات التي شكَّلت محور انشغالاته الأدبية والفلسفية والسياسية.
ولد هلسا في إحدى قرى ماعين قرب مادبا في الأردن. ولا يعرف التاريخ الدقيق لهجرة والده الكركيّ سلامة الهَلسا من الكرك إلى قرية ماعين في مادبا، نهايات القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين. وقد درس غالب في مدرسة ماعين الابتدائيّة بالقرية، وتجاوز أربع سنوات دراسية بسنتين لنبوغه. ذهب غالب من القرية إلى مادبا، ليقيم عند شقيقه المحامي حنّا هلسا بعمر التاسعة للدراسة في مدرسة مادبا لمدة سنة. ويزعم صالح الحمارنة في كتابه عن غالب هلسا أن هلسا كان الأصغر سناً في الصف أثناء دراسته في مدرسة الاتحاد الإنجيلية الأميركية في مدينة مادبا، وأنه كان “متوقد الذهن، سريع البديهة، لكنه يقضي وقتا في المناكفة والمشاكسة اللفظية، والجدل حول كل شيء، فإذا خلا بنفسه فمع الكتاب”.
كان غالب هلسا قد ترك الأردن في سن الثامنة عشرة إلى بيروت للدراسة في الجامعة الأمريكية هناك. لكن الشاب – الذي كان قد بدأ محاولة الكتابة في الرابعة عشرة من عمره – أُجبر على قطع إقامته في لبنان وعلى العودة إلى وطنه، ثم على مغادرته مرة أخرى إلى بغداد، ثم على ترك بغداد إلى القاهرة، حيث أنهى دراسته للصحافة في الجامعة الأمريكية. وأقام غالب في القاهرة لثلاثة وعشرين عاماً متصلة، يعمل في الترجمة الصحفية، ويكتب قصصاً وروايات، ويترجم الأدب والنقد، ويؤثر ـ بشخصه وبأعماله وبثقافته ـ في جيل الروائيين والقصاصين والشعراء الذي أُطلق عليه ـ فيما بعد ـ (جيل الستينيات). وفي عام 1976، أُجبر غالب هلسا على ترك القاهرة إلى بغداد، التي غادرها بعد ثلاث سنوات إلى بيروت، حيث أقام إلى أن اجتاحت القوات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية، فحمل السلاح، وظل في خنادق القتال الأمامية، وكتب عن هذه الفترة الهامة نصوصاً تجمع بين التحقيق الصحفي والقصة ثم رَحَل مع المقاتلين الفلسطينيين على ظهر إحدى البواخر إلى عدن، ومنها إلى إثيوبيا ثم إلى برلين. وأخيراً حطّ به الرحال في دمشق التي أقام بها إلى أن توفي بعد سبع سنوات من وصوله إليها.
العالم الروائي عند غالب هلسا عالم واحد، متنوع المناحي وعميق، لكنه محدد ومتواتر القسمات، يدور أساساً حول شخصية الراوي التي تأتينا أحياناً بضمير المتكلم، وأحياناً أخرى بضمير المفرد الغائب الذي ينبثق العالم الروائي منه. وفي أحيان كثيرة تبدو شخصية الكاتب سافرة، بملامحها المعروفة من حياة الكاتب. وفي أحيان أخرى يتخذ اسمه صريحاً.
لم يكن غالب هلسا روائياً أو كاتب قصة قصيرة فقط، بل كان من ذلك النوع من المثقفين العرب العضويين، المنشغلين بالسياسة والثقافة والفكر، يساجلُ في تلك الصيغ المختلفة من رؤية العالم، طامحاً إلى تحديث المجتمعات العربية، لا إلى تحديث الثقافة أو تطوير الأشكال الإبداعية فقط، بل إلى تطوير الرؤى النظرية التي نفسر بها حركة المجتمعات، والثقافة، والسياسة، والفكر في الآن نفسه. انطلاقاً من هذه الرؤية أنجز غالب في العمر القصير، نسبياً، الذي عاشه، أعمالاً في الرواية، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، والفلسفة والفكر، والترجمة، ومقالات كثيرة في السجال السياسي، جاعلاً من الأشكال المتعددة للكتابة طرقاً مختلفة للنظر إلى الوجود الإنساني، مقلّباً هذا الوجود على وجوهه المتعددة من خلال السرد، والفكر، وقراءة التجارب الثقافية والفكرية للشعوب والمجتمعات الأخرى، ساعياً إلى فهم الإنسان العربي، والمجتمعات العربية. فإلى جانب رواياته ومجموعتيه القصصيتين، كتب غالب عن “العالم مادة وحركة” (في محاولة ماركسية مادية لفهم بعض مفكري المعتزلة)، و”الجهل في معركة الحضارة” (في رد على كتاب لمنير شفيق)، و”قراءات في أعمال: يوسف الصايغ، يوسف إدريس، جبرا إبراهيم جبرا، حنّا مينه”، كما ترجم “الحروب الصليبية” للروائي الإسرائيلي عاموس عوز، و”الحارس في حقل الشوفان” للروائي الأمريكي جي. دي. سالينجر، و”جماليات المكان” للفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار. وهو ما يدلُّ على تعدد انشغالاته وطاقته الفكرية والإبداعية التي جعلته واحداً من الكتاب المؤثرين في الثقافة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، والذين يستحقون مواصلة النظر في منجزهم الإبداعي والنقدي والفكري.

في وسط البلد، في ستّينيّات القاهرة وسبيعينيّاتها، حيث كان العالم أكثر رحابة واستيعاباً للاختلاف والتنوّع الثقافي، التقى غالب هلسا بكلّ من يحيى الطاهر عبد الله، ومحمد البساطي، وعبد الحكيم قاسم، وبهاء طاهر، وعبد الرحمن الأبنودي، وأبو المعاطي أبو النجا، وعلاء الديب، وسليمان فياض، وعبد المحسن طه بدر وغيرهم الكثير من كُتَّاب تلك الحقبة التي كانت محتشدة بروائيين، وشعراء، ونقَّاد، ومفكِّرين، ومترجمين، وصحافيين من طراز متفرّد، كما كانت محتشدة- أيضاً- في الوقت ذاته، بشعارات السرديّات الكبرى والأحلام الثورية التي تترقّب عالماً أكثر عدلاً وأكثر حرية.
إن الواقع العربي المعيش يقول إن ثمة كُتَّاباً بأعينهم اختاروا أوطاناً أخرى، أو مجتمعات بديلة، اندمجوا فيها دون إحساس بالنفي المباشر، ولم تعبّر مرويّاتهم عن المنفَى بتمثيلاته السياسية المباشرة، بل راحت تقدّم وجوهاً شتّى للاغتراب المكاني أو الوجودي، إلى جوار تمثيلات سردية وثقافية أخرى مثل أغلب نصوص غالب هلسا، وأهداف سويف، مثلاً، في روايتيها «في عين الشمس – In the Eye of the Sun» و«خارطة الحب – The Map of Love»، وغيرهما من الكتّاب والأدباء. لذا، فقد استطاع غالب هلسا أن يخلق ما أطلق عليه فخري صالح اسم «الجغرافيا التخيّلية» لرواياته وقصصه خلال تلك الحقبة الزمنية التي عمل فيها في كلّ من وكالة أنباء الصين الجديدة، ثمَّ وكالة أنباء ألمانيا الديموقراطية لفترة تتجاوز الستة عشر عاماً، مشاركاً بفاعلية في الحياة الثقافية المصرية إلى أن أُبعِد من القاهرة بأمر من السادات في نهاية السبعينيات، مغادراً إلى بغداد ثمَّ إلى بيروت، وبعدها دمشق. ويمكن للباحث أو للناقد المعنِيّ بسردية هلسا الرجوع إلى رواياته وقصصه القصيرة، وفحصها وفق هذا المنظور الذي قد يفسِّر لنا الكيفية التي استطاع بها غالب هلسا تشييد «جغرافيا بديلة»؛ هي مزيج من صور القاهرة، وبغداد، وعمّان، وبيروت وغيرها من المدن العربيّة التي أقام فيها أو تَنَقَّل بينها.
رؤية هلسا لعلاقة الأدب والفن بالسياسة:
وعلى الرغم من انحياز غالب المعلن للماركسية، بل واندماجه في أنشطة بعض منظماتها (السرية والعلنية)، إلا أنه آمن بمفهوم صارم للأدب، يتمسك بفهم عميق لحدود دور الأدب والسياسة، والتخوم الضرورية للتفريق بين الفضاء العام لكل منهما، كما حرص على تعمق العلاقة الجدلية بينهما وبين عملية الوعي الاجتماعي، التي تعلي من قيمة الممارسة العملية، وترفض الادعاء بأسبقية الفكر على الواقع، أو “أسبقية التفكير على واقع الكتابة، بصورة أخص” (كتاب “المغترب الأبدي يتحدث – حوارات مع غالب هلسا”، وكل الاقتباسات التالية من هذا الكتاب).
يشرح هلسا رؤيته لهذه القضية على النحو التالي: “إن كل أدب هو أدب سياسي. بمعنى أنه يحدد موقفاً سياسياً، يدعو إليه. ولكن وسيلة الأدب في التعبير عن الموقف تختلف عن وسيلة السياسي، وأما خارج التعبير الأدبي، فأعتقد أن الأديب يجب أن يكون له موقف وانتماء سياسيان”.. “ويعني بهذا أن يكون الموقف السياسي منحازا إلى الشعب”.
وهذا الفهم، من وجهة نظر هلسا، ينفي ما كان دارجا من تطبيق ميكانيكي فج لنظريات ما كان يعرف باسم “الواقعية الاشتراكية”، التي تعكس صورا نمطية لنماذج بشرية “سابقة الصنع”، مغايرة للواقع، مسطحة، بلا معاناة جوانية أو مكابدة أو صراع حقيقي أو تطور!
ذلك أن الفن، كما يرى هلسا، يذهب إلى “أعمق من مجرد الإقناع بقضايا وتوجهات خاصة”…. إن مهمته السريان كالنسغ إلى الأعماق، و”التأثير في أصول التكوين الإنساني وينابيع الفعل، وبما يجعل المتلقي يعيد صياغة عالمه… إنه لفنان بائس ذلك الذي يحاول أن يجعل فنه في خدمة قضايا آنية، فما يبدعه مجرد دعاية، ولن يصل أبدا إلى مستوى الفن!”
تبدوا لي رؤية هالسا لتلك العلاقة المتشابكة للأدب والفن بالسياسة، غنية وعميقة بل وأيضًا هادية. بعد الاطلاع على كتابات وأراء ورؤى هلسا، أصبحت من أكثر المتحمسين له وللبحث في فكره وأدبه، فإذا شاركني القارئ الكريم بعض من هذا الحماس، فاستأذنه أن يكتب في التعليقات على المقال، فهذا يعني أن هناك لي شريك أو شركاء في هذا الحماس والاعجاب، مما يدفع للبحث ونشر المزيد من المقالات في وحول فكر وأدب غالب هالسا.
لمراسلة المجلة بمواد للنشر في صورة ملف word عبر هذا الايميل:
salontafker@gmail.com
اشترك في صفحة تفكير الثقافية لتصلك مقالات تفكير اضغط هنا
تابعنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:
تابع قناة جمال عمر علي يوتيوب شاهد قناة تفكير علي يوتيوب تابع تسجيلات تفكير الصوتية علي تليجرام انضم لصالون تفكير علي فيسبوك
شارك المحتوى
اكتشاف المزيد من تفكير
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




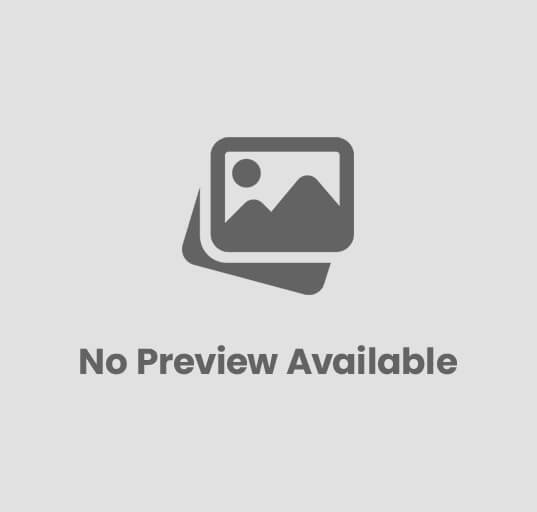







اترك رد